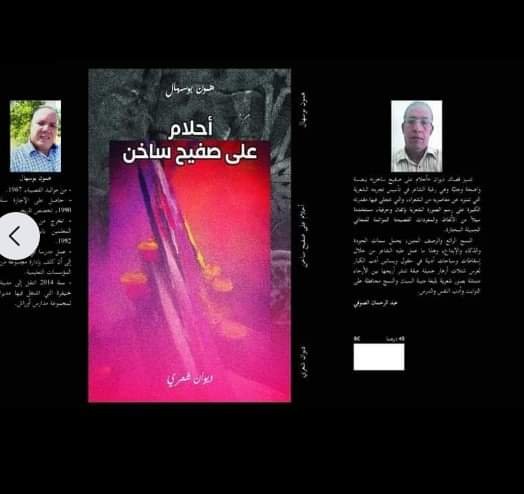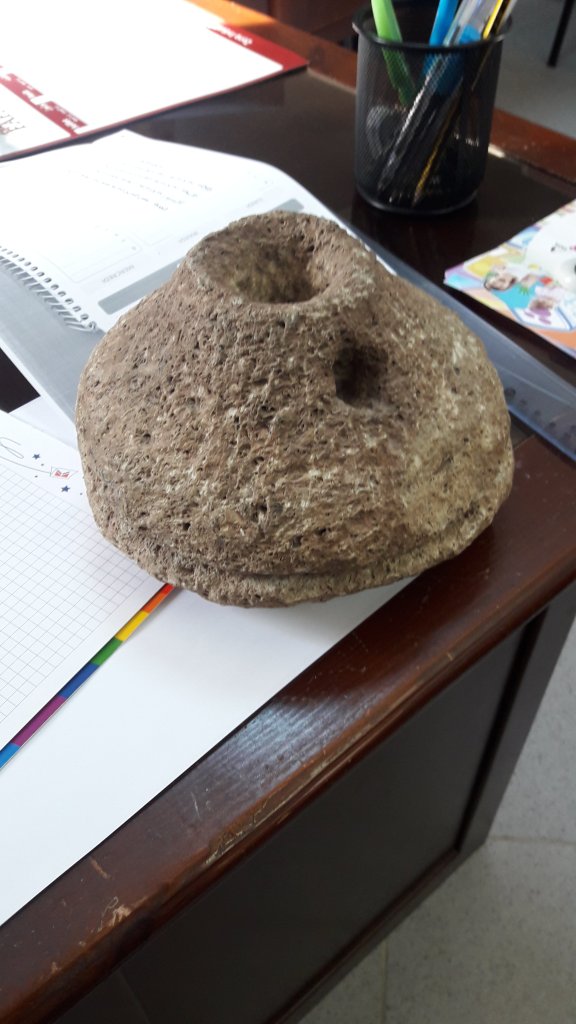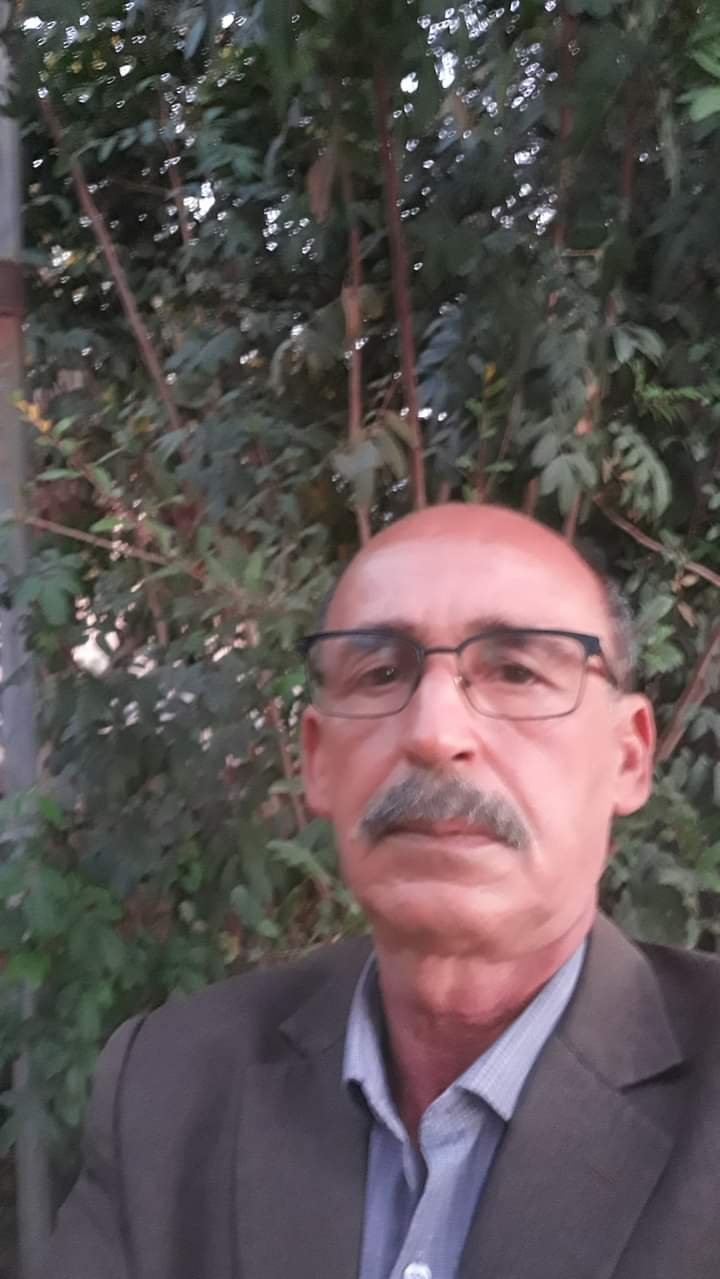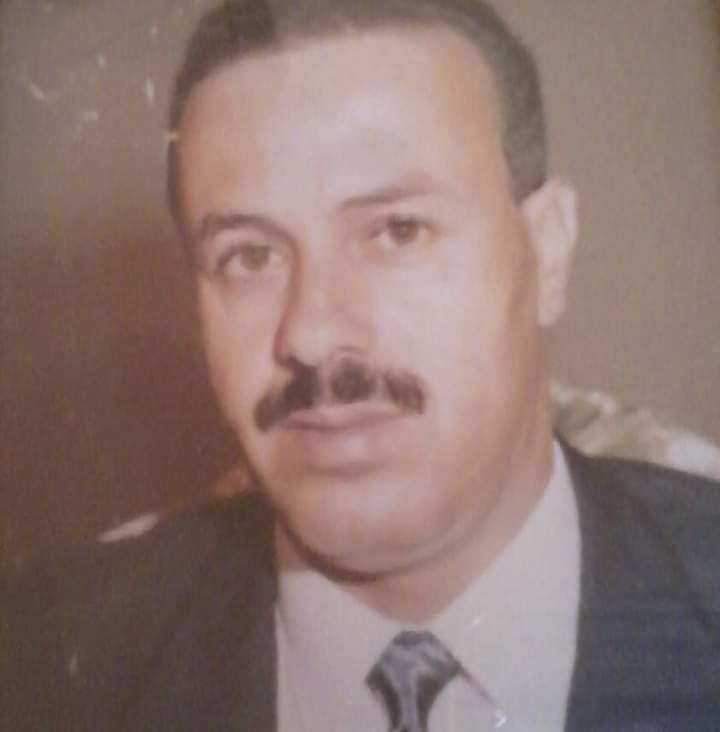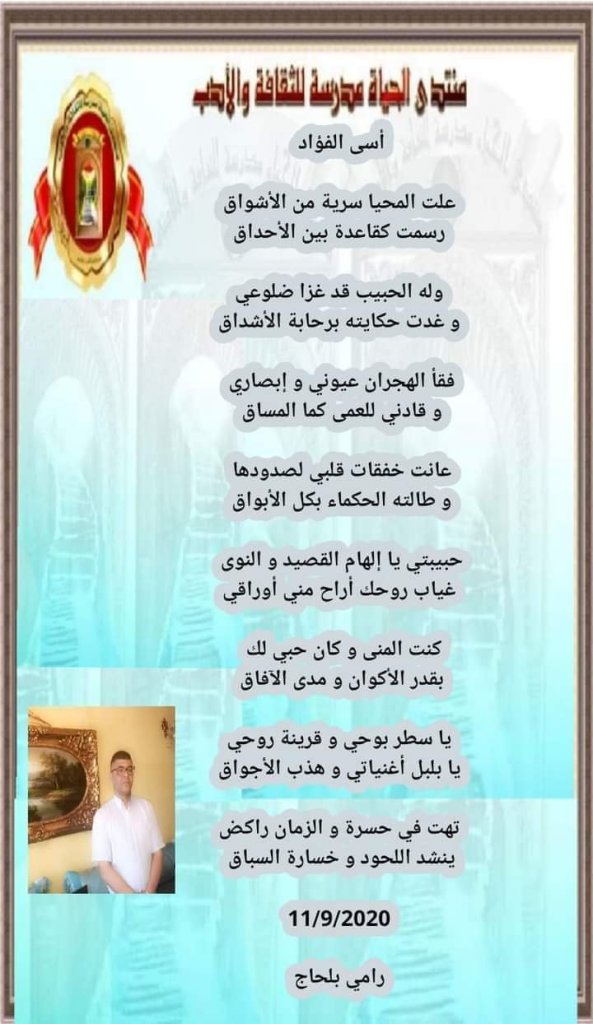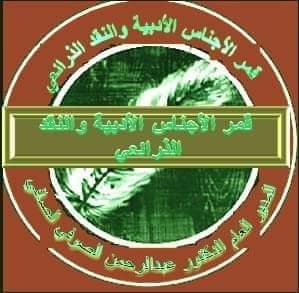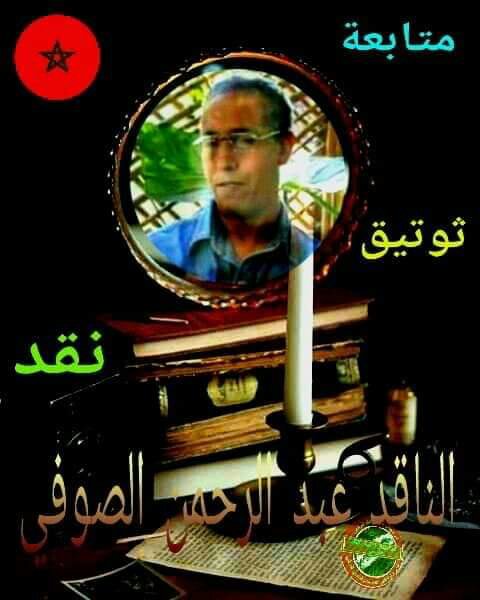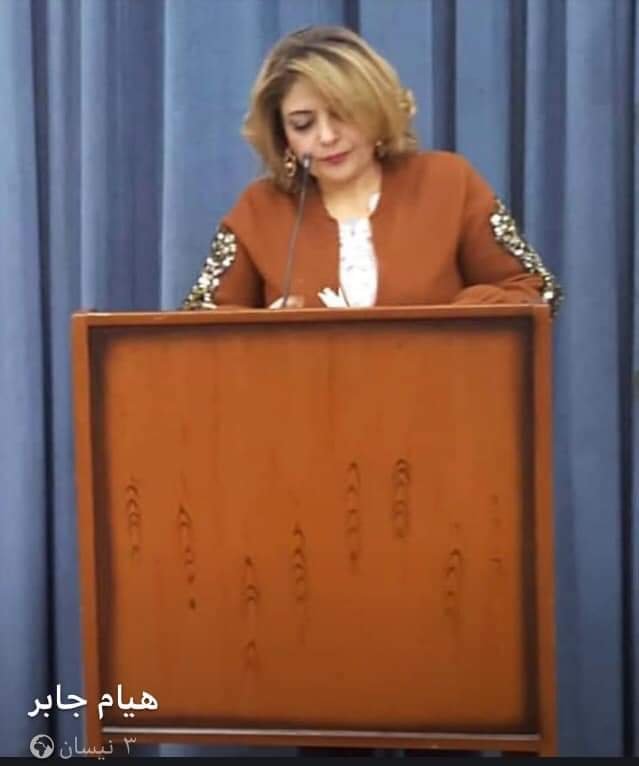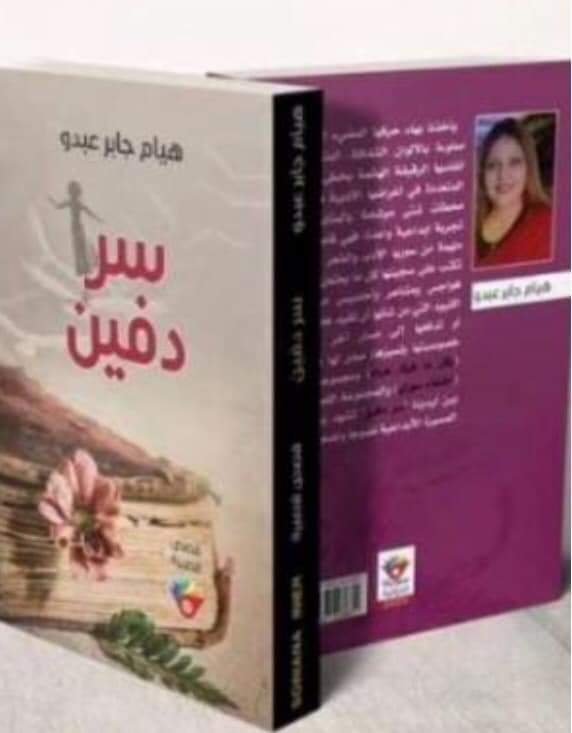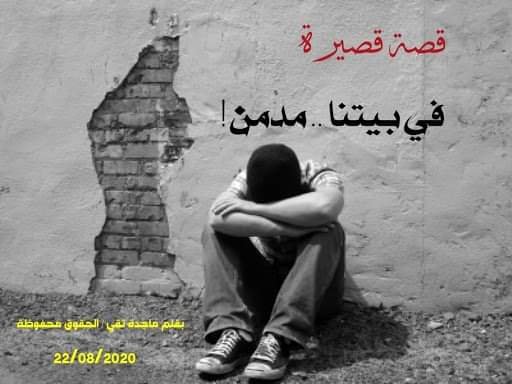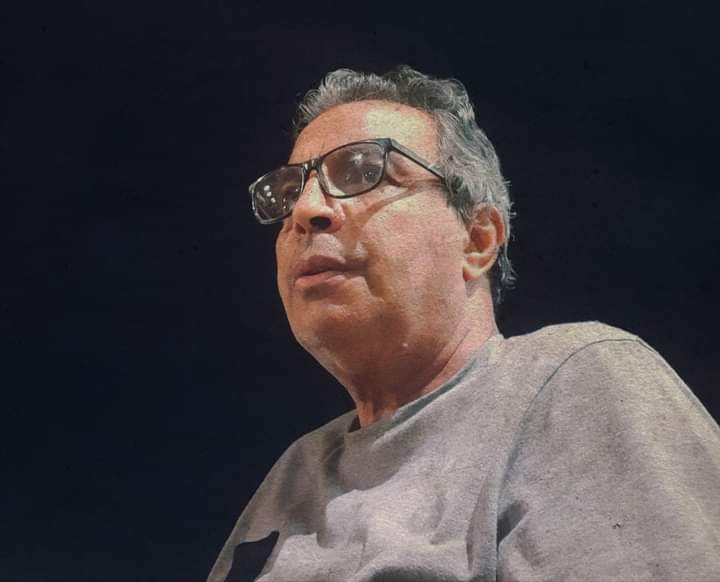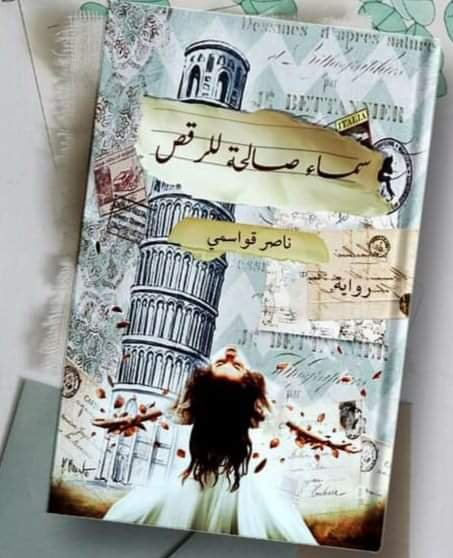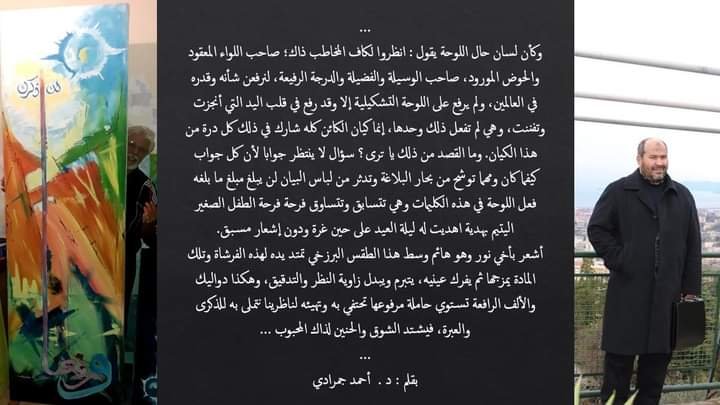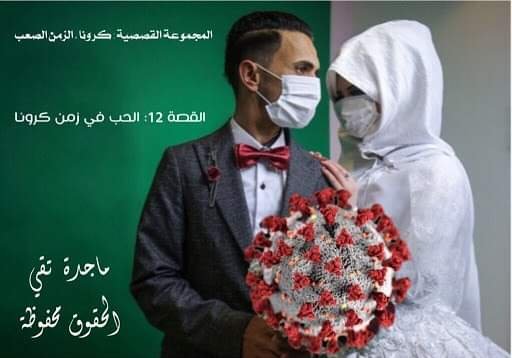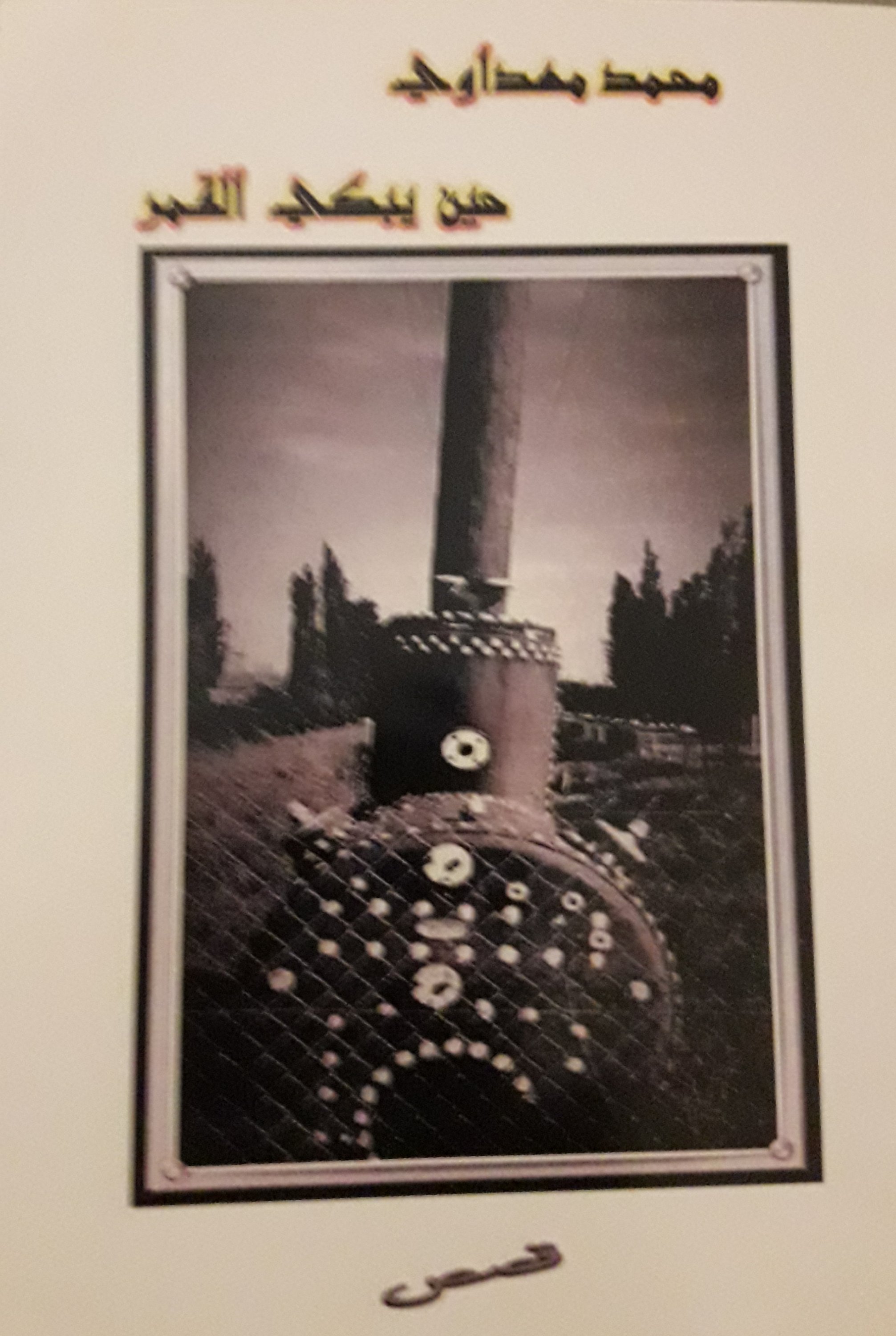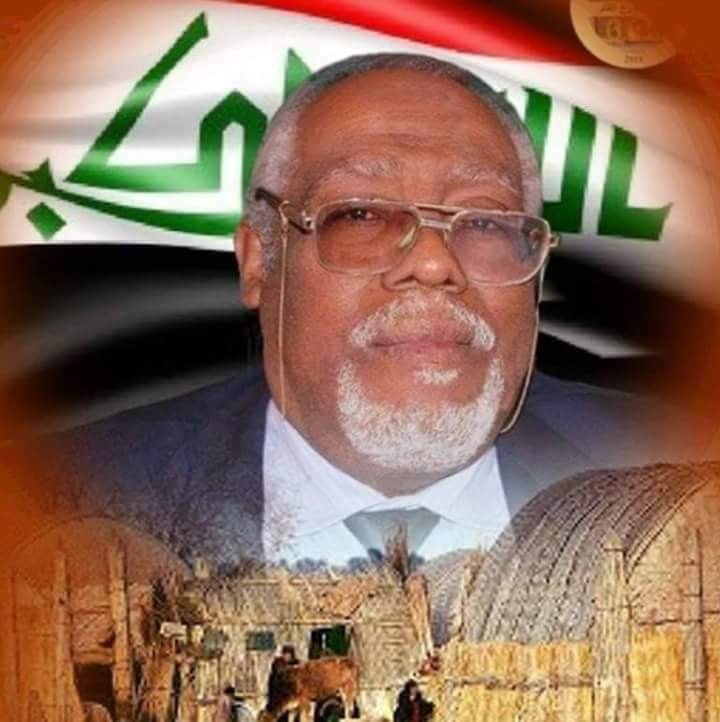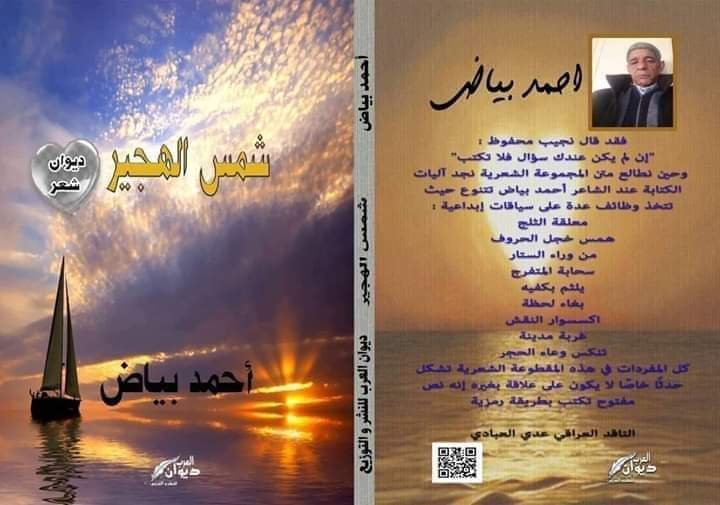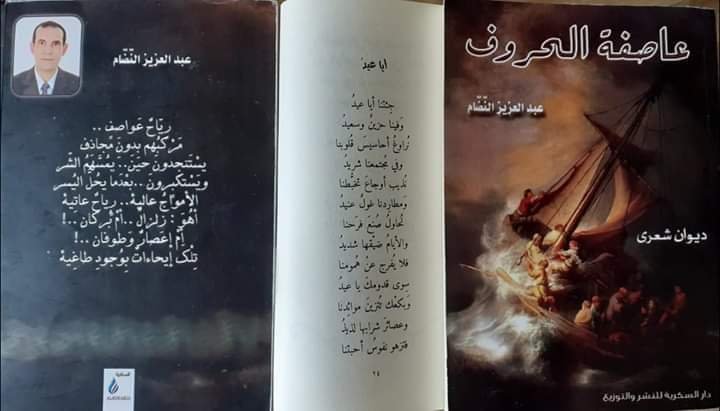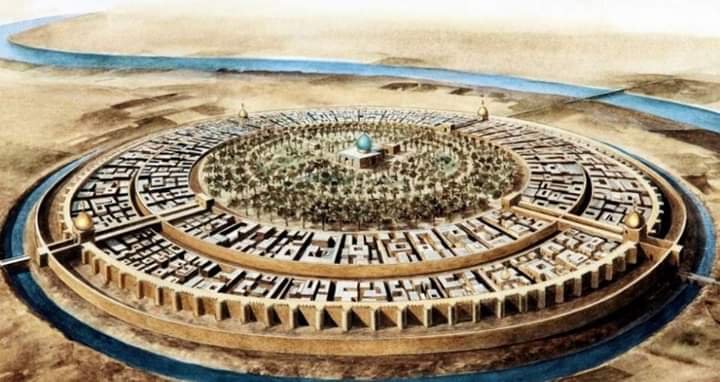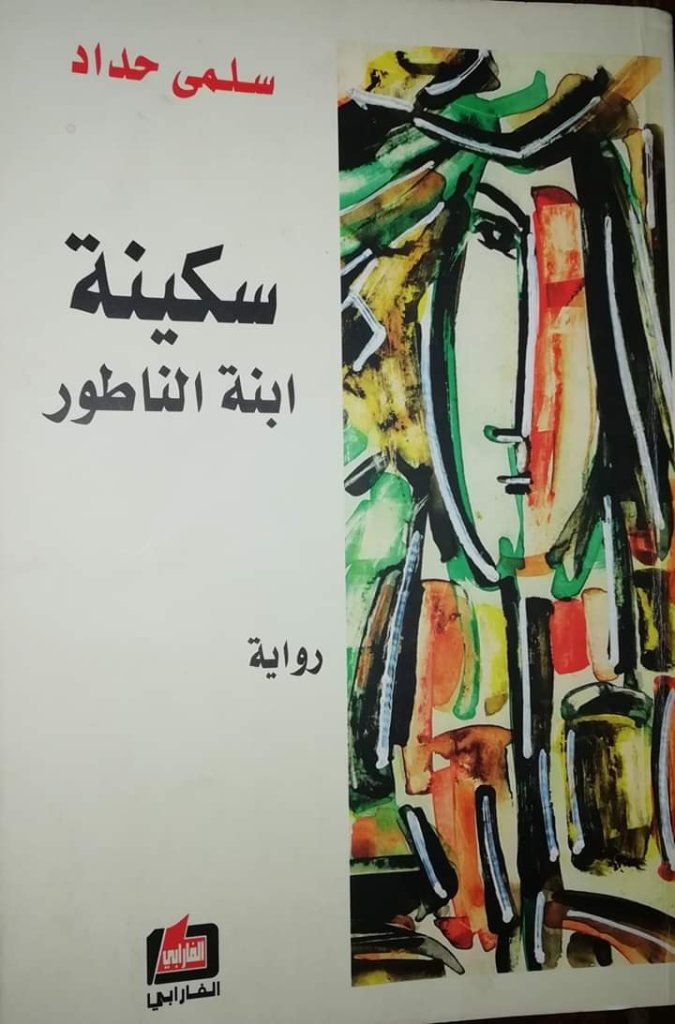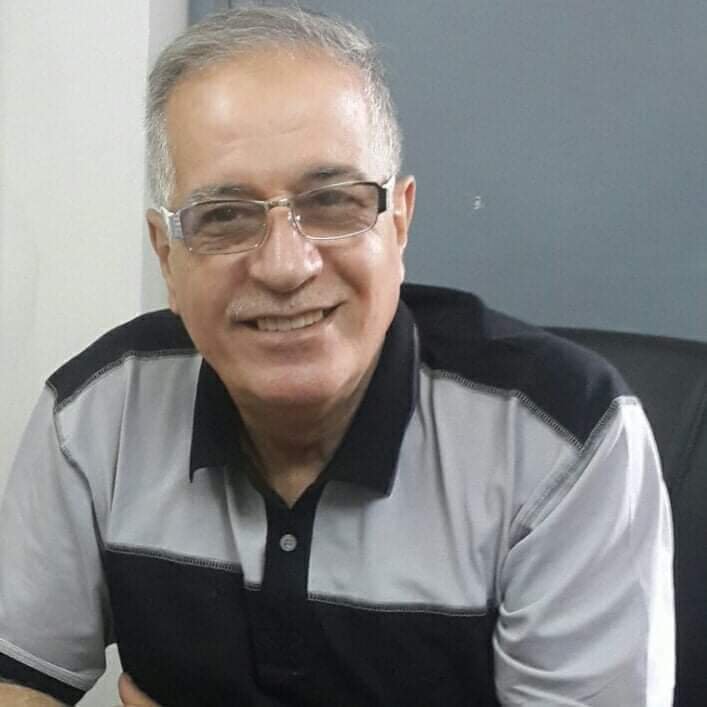عنوان الدراسة النقدية الذرائعية المستقطعة : (استراتجية الكتابة في ثيمة الموت / ثلاثية : فلسفة الخوف من الموت
فلسفة الموت – الاستثمار في الألم زمن جائحة كورونا ) في (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) لمحمد الخرباش Mohammed Elkharbach
إهداء : أهدي هذا المجهود المتواضع لروحي المعتقل السياسي والصحفي المرحوم ” حسن السوسي ” والمرحوم / الشاعر العراقي ” عبدالجبار الفياض “ شاعر الدراما الفلسفية .
ملاحظة : الدراسة النقدية نشرت في العديد من المواقع الإليكترونية الوطنية والدولية .
إعداد: عبدالرحمان الصوفي/ المغرب
مقدمة :
لقد شكل الموت عبر عصور طويلة هوسا فكريا لكل الشعوب، لذلك شيد الفراعنة الأهرامات كقبور، مثلما تشيد البيوت للأحياء . صاحب تشيد القبور في حضارات إنسانية قديمة ظهور الكثير من طقوس وشعائر (الموت ) التي اختلفت في أساليب دفن الجثث وتوديع الجنائز و مواكب الحزن والعزاء . هذه الطقوس الجنائزية ستعرف هزة مدوية زمن جائحة كرونا ، فالكثير من الناس لم يستطيعوا توديع أحبتهم إلى مثواهم الأخير، نتيجة الإجراءات الاحترازية المشددة ، ونتيجة الانتشار السريع لهذا الفيروس القاتل الذي أصبح الموت فيه يلتف بكل بيت زارعا الخوف والهلع في نفوس كل الناس . الموت الذي لم تكن تخشاه
الإنسانية لحظة الحروب وأزمات المجاعة و الكوارث الطبيعية والأمراض الكثيرة التي عرفتها البشرية عبر مر تاريخها…
لقد اهتم الإسلام اهتماماً كبيرا بالموت وسكراته من خلال تكرار هذه الكلمة ومرادفاتها في القرآن الكريم.
يعرفها المسلم ويقتنع بحتميتها التي لا تخيفه ، حيث ورد ذكرها 165 مرة .
لكن أخطر ما جاء به هذا الفيروس ( التباعد الاجتماعي )، الذي مس بقدسية الشعائر الدينة ( صلاة الجماعة – صلاة الجمعة – شعائر ليلة القدر – صلاة العيدين – العمرة – الحج …) .
ستغوص دراستنا النقدية في ثيمة الموت، دون المكونات الأخرى للرواية عموما ، وحسب ما تقتضيه آلية الاستقطاع النقدي الذرائعي ، زمن جائحة كورونا في (( مذكرات واقعية (رواية ) رحيل بلا وداع )) (1) هذا الموت الذي ورد في صيغة سرد الحدث المتصاعد زمنيا ( موت الأم والأب ومعارف وأصدقاء ) ، ومن خلال سرد التداعي الحر وتذكر الماضي لشخصيات كثيرة ذكرت قرابتها بالسارد/الكاتب .
1 – المدخل البصري ل ((مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) لمحمد الخرباش.
تحمل الواجهة الأمامية للغلاف العنوان (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) ، وفي أسفل الغلاف اسم صاحب المذكرات ” محمد الخرباش . وتتوسط الواجهة لوحة تشكيلية ، يظهر فيها طبيب جالس وهو في حالة عياء وإرهاق مرتديا لباس الأطباء زمن كورونا . ويظهر كذلك في اللوحة شخص في طريق المغادرة التي ليست بعدها عودة . اللوحة من تصميم “مريم فتحى عبد المقصود ، العمر 26
عاما خريجه كلية قانون تعمل في تصميم أغلفه الكتب منذ عشر أعوام و تعمل في تصميم اللوجوهات والهوايات البصرية و الموشن جرافيك ، صممت العديد من البراندات العالمية في البرازيل و اسبانيا عملت في عدة دور نشر كدار همسه للنشر والتوزيع وتعمل على تنسيق الكتب بأنواعها …”(2)
تضم الرواية 206 صفحة مبوبة كالآتي :
الإهداء – قبل غروب الشمس – بين العزلة والأمل – مولاي أحمد – لقاء ثم وداع – أيام من الجحيم – الجندي المجهول – موسم الرحيل ” . الطبعة الأولى للرواية في شهر دجنبر 2021
أما الواجهة الخلفية للكتاب فتتصدرها في الأعلى صورة المؤلف ، وسيرته بشكل مختصر جدا . يتوسط هذه الواجهة الآتي : ” لقد اقترب منا اقتراب من لا يستأذن على أحد ، وربما تسلل إلى رئة كل واحد منا في غفلة أو تهاون غير مقصود، فرضته الأعراف والظروف وقريبا سيكشر هذا الوباء عن أنيابه ، في محاولة لتمزيق شملنا ، فيروس حقير ، لم يقدر حتى ظروف الوفاة، وفقد الوالدة ، فالجنود في أعتى الحروب يتنازلون أحيانا عن دورهم العسكري ، وربما يتنزهون عن طعن أحد من الخلف ؛ فيقدرون الظروف الإنسانية ، لكن هذا الغريب المتحور لا يعرف شيئا عن المبادئ ، وهمه الوحيد وملاذه حتى يبقى على قيد الحياة هو ان يعشش في خلايا رئة كل واحد منا في أقرب وقت ..” .
2 – عتبات العنوان في (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) .
أ – المفتاحية الأولى / الدعامة النسبية :
-رحيل :
لقد استغلت الفلسفة كل آلياتها وأدواتها للبحث والتنقيب والاستغوار في فكرة الموت وما تحمله ضمنيا من مفاهيم مصاحبة لها ضمن علاقات إنسانية ، ألزمت أن يوقفها الوجع ( زمن جائحة كورونا ) بشكل مفاجئ ( من الوجود إلى العدم ) ,,, لقد كتب الله على الإنسان الرحيل منذ خلقه الأول .
يقول أبو الطيب المتنبي :
وما الموت إلا سارق دق شخصه ** يصول بلا كف ويسعى بلا رجل
إذا ما تأملت الزمان وصرفه ** تيقنت أن الموت ضرب من القتل
وما الدهر أهل أن تؤمل عنده ** حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل ( 3)
إن موضوع الرحيل الذي كتب حوله العديد من الشعراء والفلاسفة في كل الأزمنة السابقة ، قبل ظهور فيروس كورونا يختلف عن رحيل الأحبة زمن الجائحة . كما أن الرحيل ( ارحل ) كان شعار الجماهير العربية خلال ما سمي ب ” الربيع العربي ” إلا ان فيروس كورونا اختار رحيلا من نوع خاص لا يميز فيه بين الصالحين والمفسدين .
ب – المفتاحية الثانية / الدعامة المطلقة :
-بلا وداع :
يقول أبيقور:«عندما يحل موتي أكون قد أصبحت غير موجود.. وطالما أنا موجود يكون موتي لما يأتي بعد..». ( 4 ) . إن الإنسان عند مرضه أو شيخوخته يرى الوداع مساحة أمل تضيق أكثر محدثة جرحا في الذاكرة المتجهة نحو الماضي دون المستقبل ، فيصبح شعور الإنسان مقتنعا بالزوال المطلق ، وليس له إلا التوديع ( الوداع ) سبيلا ، ” أمام استحالة عدم الذات ” أي أن المرء لا يــستــطيع معايشة فكرة دنو الحتف إلا أن هذه الفكرة تقفز إلى العقل ، والأمر شبيه ب الدين المقلق ” لاسيما وأن موعد الاستحقاق ( الموت )
مجهول ومحتم في الآن نفسه…أما زمن انتشار فيروس كورونا فقد تزايدت مواجع حالات الوفاة، مع غياب طقوس الوداع والمراسم الجنائزية بسبب قيود الحجر الصحي ، فجل أهالي الموتى لم يحضوا بأغلى أمنية لهم ، وهي توديع ( الوداع ) أحبائهم وخاصة الأب والأم ، ويمر الحداد في عزلة لم يسبق ان عرف التاريخ شبيها لها بين الأسر قبل زمن ظهور الفيروس القاتل، ويتحمل أهالي المفقودين الصدمة وحدهم دون مشاركة الأقارب والأصدقاء، ودونما جنازة لائقة، تشفي غليل الوداع الأخير الذي يحقق أمنيتهم في توديع أحبابهم .
قال الشاعر محمد بن مقسم :
فراق الأحبة داء دخيل ** ويوم الرحيل لنفس رحيل
سمعت ببينك فاعتادني ** غليل بقلبي وحزن طويل
أهذا ولم يك يوم الفراق ** فإن كان لا كان زاد الغليل
وأيقنت أني به تالف ** ما قد وصفت عليه دليل
حياة الخليل حضور الخليل ** ويفنى إذا غاب عنه الخليل (5)
3 – في الجنس الأدبي (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع))
أ – سيرة ذاتية ؟ مذكرات ؟ رواية ؟
صعب جدا إيجاد تعريف جامع أو رسم حدود فاصلة بين السيرة الذاتية والمذكرات والرواية، نظراً لما تثيره هذه الحدود من إشكالات ومواقف ورؤى متباينة ( نظريات الأجناس الأدبية ) ، لأن نوع وطبيعة العلاقة أو الصلة بينها مرتبطة بآراء المناهج النقدية، كالمنهج التاريخي، والمنهج النفسي … ومن هذه الإشكالات كذلك ما يتعلق بعلاقة هذه الأنواع مع غيرها من الأنواع الأدبية ذات الشجرة الأجناسية الواحدة، كالمذكرات، واليوميات، والرواية ، السيرية ، الرحلات… إذ تتشابه هذه الأنواع في بعض مرتكزاتها وتتداخل، مما يصعب مهمةالتفريق بين نوع/ جنس أدبي وآخر .
المذكرات هي من الأصناف الأدبية ( مجموعة من الذكريات ) كتبها المرء عن حوادث وقعت له في حياته في فترة زمنية تقصر كثيرا عن الفترة الزمنية التي تتسم بها السيرة الذاتية والتي تتخذ من الفرد / الكاتب موضوعا …
يقول ” إلياس فركوح ” : ” وتشتبك الشخصيّةُ الكاتبةُ/المكتوبة ،إنْ كانت سيرة المؤلف بقلمه، أو أقنعة الروائي بالضرورة في تدوينِ خُطاطةٍ تقتربُ من الشهادة:
الشهادة على الذات، والشهادة على الواقع. الشهادة على الذات في تقاطعها مع الواقع وافتراقها عنه في الآن نفسه، والشهادة على أنَّ وجودهما معاً لا يستقيمُ أو يكون بمعزلٍ عن الكتابة، أو بغيرها، أو خارجها. وتحديداً خارج هذه الكتابة! وإلاّ، لماذا كانت في الأصل؟ … كأننا نقولُ بأنْ لا وجود لذواتنا الكُليّة؛ إذ هي تذوب وتتلاشى وتنْسى وتزولُ في طيّات الآفل والمنقضي! كأننا بالكتابةِ نقاومُ المحوَ، أو الإلغاء، أو التزوير، فـ” ننهضُ بها من بين أجداث الموتى” ؛ فالمكتوبُ باقٍ يشهدُ على كاتبٍ فانٍ…” (6)
4 – السيرة الذاتية للأديب والشاعر ” محمد الخرباش
-محمد الخرباش، من مواليد مدينة طنجة، و بالضبط في 25/09/1979 ..
-الطفولة بين حي بئر الشعيري بيني مكادة وحي دار البارود بالمدينة القديمة .
-البكالوريا ثانوية ابن الخطيب موسم 97/98 آداب عصرية.
-حاصل على الإجازة في القانون الخاص الموسم الجامعي 2002 و2003
-التحق بهيئة المحامين بطنجة بتاريخ 4/7/2007 بعد حصوله على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
-فاعل جمعوي ومدني انخرط في العديد من الجمعيات المدنية بحيث ترأس جمعية بيت المواطنة وتقلد مهمة كاتب عام جمعية جسور للتنمية المندمجة وغيرها من جمعيات المجتمع المدني بطنجة
-شاعر له أعمال عديدة وصدر له بإبريل2021 ديوان بعنوان تراتيل الحنين كما شارك بقصائده في بعض أعداد الموسوعة الحديثة للشعراء العرب التي تصدر بجمهورية مصر العربية.
آخر إصداراته رواية رحيل بلا وداع دجنبر 2021 ) (7 )
5 – ثيمة فلسفة الخوف من الموت زمن جائحة كورونا في (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) لمحمد الخرباش .
بعد ظهوره كويد – 19 في مدينة ووهان في الصين في أواخر 2019 انتشر خبره في جميع وسائل الإعلام العالمية وصاحبت هذه الأخبار سرعة انتشاره في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الأنشطة والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس في جميع أنحاء العالم ، وعرضت حياتهم لخطر الخوف من الموت.
لقد اهتمت الفلسفة التأملية عبر أزمنتها المختلفة ( مختلف توجهات الفلسفة التأملية ) بموضوع الخوف من الموت ،حيث يقول الفيلسوف “مسكويه ” : “إن الخوفَ من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة، أو لا يعلم إلى أين تصير نفسه، أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه، فقد انحلت ذاته، وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور، وأن العالم سيبقى موجودا بعده وهو ليس بموجود فيه، كما يظنه من يجعل بقاء النفس وكيفية المعاد، أو لأنه يظن أن للموت ألما عظيما غير ألم الأمراض التي ربما تقدمته وأدت إليه وكانت سبب حلوله، أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت، أو لأنه متحير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت ” (8)
إن الخوف من الموت امتد في (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) من الصفحة 9 إلى الصفحة 46 ( المغرب – إسبانيا – بلجيكا ) ، وهيمن الموت على باقي الصفحات الأخرى للرواية ، وخاصة عند ما أصيبت العائلة والكاتب/السارد بالوباء .
يظهر الخوف من الموت جليا مع مطلع الصفحات الأولى ، و مما جاء في الصفحات الأولى للرواية
” إنه أمر تافه متابعة هذا الحدث البعيد والغامض بهذا الشغف والاهتمام ! كيف لا تعلم أختي أن كل شيء قادم من الصين لا شك في أنه مزيف !؟ وقد استقر هذا التصور لدى مجانين البشر قبل عقلائهم ، وهذا الفيروس أيضا سيكون درجة ثانية في عالم الفيروسات تماما ككل منتجات الصين الصناعية ، أو كما نقول بالعامية : “فيروس ماشي دوريجين ” ، ولن يقوى على الصمود طويلا نعم ، إنها السلع الصينية المقلدة التي اعتدناها ! ” ( ص 10)
الخوف من الموت لا تتدخل في العقلانية بإقناع أبدا . ولا يستبعد بالتقليل من شأنه …إنه الفيروس التي لم تعرف له البشرية مثيلا ، لذلك نجد دواعي الخوف من الموت محاولة لاستبعاده مسافة ومنطقا و استدلالا وحجاجا …
يواصل ” مسكويه ” مناقشة هواجس الموت بصورة عقلانية ويقول: ” أما من يخاف من الموت لأنه لا يعلم إلى أين تصير نفسه أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحلّ وبطل تركيبه فقد انحلّت ذاته وبطلت نفسه، وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد، فليس يخاف الموت على الحقيقة، وإنما يجعل ما ينبغي أن يعلمه، فالجهل إذًا هو المخوف إذ هو سبب الخوف، وهذا الجهل هو الذي حمل الحكماء على طلب العلم والتعب به وتركوا لأجله اللذات الجسمانية وراحات البدن واختاروا عليه النصب والسهر، ورأوا أن الراحة التي تكون من الجهل هي الراحة الحقيقية وأن التعب الحقيقي هو تعب الجهل لأنه مرض مزمن للنفس، والبرء منه خلاص لها وراحة سر مدية، ولذة أبدية ” (9)
إن جهل الإنسانية بمصيرها هو ما زرع فيها الخوف من الموت ، ولأنها هيأت له كل الأسباب المعجلة بظهوره وتفشيه ، من تدمير للكون وتسابق في اختراعات التدمير . ” إنه مجرد فيروس لا يرى بالعين المجردة …ذلك العفريت الذي استطاع أن يقلب الدنيا رأسا على عقب ، وأن يحول حياتنا إلى جحيم ! فلقد أرغمنا على عدم احتضان آبائنا وأمهاتنا ، وباعد بيننا وبينهم ، حتى منعنا من التوجه إلى أعمالنا ، وسجننا داخل بيوتنا وغرفنا …الأمر الذي جعل سيلا من الأفكار تقفز إلى العقول : لقد بلغت الحضارة الإنسانية شأوا عظيما ، حيث تحدى العوامل الجوية ، واخترع من الأشياء ما جعل الحياة لعبة في يديه ..فهو يتدخل في الطبيعة ، ويحاول إنزال المطر الاصطناعي ، ويواجه أعتى الظروف المناخية بعقله وفكره ويقينه .. ثم هو الآن في أقصى حالة العجز الإنساني على أن يواجه فيروسا تعمى عيناه عن أن تراه! يستطيع بأية حال أن يجد علاجا ناجعا له ! يا إلهي ! كم نحن ضعفاء عاجزون ! مصائب هبطت علينا من السماء ، وتفجرت من تحت أرجلنا …” ( ص 36 )
إن حقيقة الخوف من الموت هو الوحيد الذي يؤكد بكل يقين أننا سنموت . ولهزم هذا الخوف و تجنبه ، تقرأ صفحات الوفيات في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتسمع الناس موجز الأخبار وبرقيات التعازي في الوسائل المرئية والمسموعة ، وتزور الناس المقابر التي لا تبتعد كثيرا عن محلات سكناهم أو اشتغالهم ، فهم يمرون بالقرب منها كل صباح ومساء ، ويحضرون الجنازات وبيوت العزاء، ويذكرون ويتذكرون أمواتهم كل لحظة وحين ، وهذا ما جعل وطأة الوباء تقل في البلدان العربية بالمقارنة بدول العالم الغربي .
يقول ” إيليا الحاوي : ” والموت عام ، لكنه ليس عميما ، لا يقبل ، في آن معا ، على الوجود كله ، الموت يتسلسل ويتمهل ، لو كان عميما لاستحال إلى عدم ، لكنه يتداور ويتحاور هو والحياة في دوامة الزمن العجيب الذي يحتضن الحياة والموت جميعا …” (10)
5 – ثيمة فلسفة الموت / قدسية الولدين :
أ – رحيل بلا وداع / الأم
من الطبيعي أن يترك موت الأم والأب آثارا نفسية على البالغ و على الطفل ، فتجربة فقد الوالدين تعتبر من أقسى التجارب إيلاما ، وتجعل كليها ( الطفل والبالغ ) يشعران بالضعف والوحدة . وتزداد وطأة الفراق والوداع زمن جائحة كورونا على مختلف الأشخاص وفي مختلف السنوات العمرية . يقول ” سامويل تايلور كولريدج : ” الأم هي الأم، هي أكثر الأشياء قدسية على قيد الحياة ” . ومما جاء في (( مذكرات واقعية ( رواية ) رحيل بلا وداع )) : “أحسست وقتها كأن كياني قد انشطر إلى قسمين، وكأن أبواب الضياع والفراغ والتيهان انفتحت علي مرة واحدة ، لطالما تخوفت من مجرد التفكير في هذا اليوم ، وها أنا أعيش تلك اللحظة الأليمة التي يغتسل فيها وجهي بدموع الرحيل ، فقد ماتت أمي … ” ( ص 75)
الأمومة هي أعظم ما تميزت بها المرأة كمخلوق على سطح الأرض، فهي التي تعطي للحنان والحب معناهما الحقيقين، كما أنها لا تمل ولا تكل من العطاء والكرم بدون انتظار مقابل .الأم هي روح الحياة وجوهرها . يطلق العنان الكاتب/السارد لقلمه في ذكره مشاعره نحو أمه، تلك المشاعر التي نشترك فيها جميعا . ” مشاعر الأمومة التي حملتها أمي ..ربما لا تختلف عن غيرها لدى الأمهات ، لكننا كنا نراها متفردة متميزة بين بنات جنسها ..لا تعرف القراءة ولا الكتابة ، لكنها رغم ذلك تطبق أحدث نظريات التربية ، ورغم انها لم تطأ قدماها كلية من كليات التربية ، فإنها بفضل الله أوتيت ذاكرة لماحة ، وعقلا راجحا ينافس كثيرا من الرجال حاملي أعلى الشهادات …” ( ص 66)
ناقش الغزالي قضية الموت في نظرته التأملية التي مزجت بين الحكمة ( الفلسفة ) و الشريعة ، يقول: “إن للإنسان حالتين، حالة قبل الموت، وحالة عند الموت، الحالة الأولى قبل الموت ينبغي أن يكون الإنسان فيها دائم الذكر للموت … فذكر الموت يطرد فضول الأمل، ويكف غرب المنى، فتهون المصائب …” ( 11)
ب – رحيل بلا وداع / مولاي أحمد :
يقول المثل الياباني : ” طيبة الأب أعلى من القمم، وطيبة الأم أعمق من المحيطات ” ، لذلك وجدنا شخصية الأب ( مولاي احمد ) تختلف عن شخصية الأب في الكثير من الروايات مثل رواية ” خريف البطريق ” ( ماركيز ) ، ورواية ” أنا الاعلى ” ( راوول باستوس ) ، ورواية ” ميرمار ” ( نجيب محفوظ ) ، ورواية ” أنا أحيا ” ( ليلى البعلبكي ) ، ورواية ” حكاية زهرة ” ( حنان الشيخ ) ، رواية ” الخندق ” ( يوسف إدريس )…روايات كثيرة اعتبرت الأبوة سلطة ذكورية مرتبطة بالعنف كسلطة (سياسية – اقتصادية – اجتماعية – فكرية …) ، بل اصبح الأب في بعض الروايات قناعا ووسيطا نقديا للسلطة…
” إن مجرد الخروج مع الوالد دواء للنفس ، وراحة من كل الضغوطات، فهو يتخلص من السلطة الأبوية ، ويطلق العنان لنفسه بكل تلقائية ، يغني لنا جميعا أغاني مطربه المفضل ” فريد الاطرش ” اغنية : ” يا قلب يا مجروح ” ، وأغنية ” الحياة حلوة بس نفهمها ” …لم يكن مولاي أحمد يعلم أن الزمان الذي نعاصره ما عاد يعكس كلمات الاغنية ، فالحياة لم تعد حلوة بعد جائحة كورونا ، وأصبحت نفسيتنا مضغوطة وقابلة للانفجار ! …” ( ص 52 و 53 )
نقطة تحول كبيرة جاءت بها جائحة كورونا في حياة كل الناس عامة ، والكاتب/السارد خاصة ،حيث أنهت مرحلة مشرقة من حياته سادتها الطمأنينة والسكينة ، وبدأت مرحلة أخرى يعتصره فيها حزن الرحيل والوداع والفراق الذي سيغير خريطة المستقبل . مهما كبر الإنسان في السن، فإحساسه بأبيه يبقى طفوليا في أعماقه ، لا يضعف مهما كبر، ولا يقل وهجه بمرور الأيام . وعندما نفقدهم نصبح مثل ” قافلة تاهت في صحراء قاحلة بعدما فقدت قائدها ودليلها” .
يرى أبو حامد الغزالي على أن النفس جوهر خالد لا يموت أبدا بموت البدن يقول: ” والنفس ليست منطبعة في البدن، بل لها العلاقة مع البدن بالتصرف والتدبير والموت انقطاع تلك العلاقة، أعني تصرفاتها وتدبيراتها عن البدن، وإنما يموت الروح الحيواني وهو بخار لطيف ينشأ من القلب ويتصاعد إلى الدماغ ومن الدماغ بواسطة العروق إلى جميع البدن، وفي كل موضع ينتهي إليه يفيد فائدة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة ” . ( 12 )
” اتجهت سيارة الاسعاف هذه المرة وهي حاملة مولاي أحمد جثة هامدة داخل صندوق موصد نحو مثواه الأخير ، لم يتسن لأبنائه ولا لأحبابه احتضان الجثة الممددة داخل سيارة الإسعاف ، ولا منحها
قبلة على يدها ، ولا حتى إلقاء نظرة أخيرة ..ما أصعب الوحدة حتى في لحظات الموت ..وما اشقاها وأتعسها تلك الحياة التي تقضي فيها سنوات العمر …” ( ص 201)
ونختم غوصنا النقدي في فلسفة الموت ( مولاي أحمد ) بما قاله الشاعر والوزير الأندلسي ابن شهيد .
ولمّا رَأيتُ العيشَ لَوَّى برَأسه … وأيقنتُ أنَّ الموتَ لا شكَّ لاحِقي
تمنّيتُ أنَّي ساكِنٌ في عَبَاَءةٍ … بأعْلى مهبِّ الرّيحِ في رأسِ شَاهِقِ (13)
المطلق لم تكن الصفة الفطرية التي خلق عليها البشر ، إن تأكيد وجود الذات، هو في قوة وجودها الذي ليس مطلقا ، بل نسبي وبالتالي فانية. إذن المطلق ليس إلا في قرار الوجود الإنساني، القرار الذي مر بالتأمل الفلسفي ، أي إنه يأتي من الحرية، هذا المطلق لا زماني في الزمان – كما يرى ” ياسبرز ” ، لأنه لا يكتمل إلا عندما يتوصل الإنسان إلى الانتصار على نفسه وإلى إتباع السبيل الذي يصبح القرار المطلق فيه الذي لا يتزعزع.
6 – الاستثمار في مآسي الناس زمن جائحة كورونا .
التفكير الأخلاقي يتداخل مع الفلسفة الأخلاقية ، يدرس كيف يفكر الناس في الصواب والخطأ في أمورهم الذاتية والموضوعية ، وكيف يطبقون القواعد الأخلاقية التي هي أساس الأخلاق الوصفية، مما يجعل الأخلاق أساسية في العلاقات والقوانين المنظمة للمجتمعات ، وبين الأفراد فيما بينهم ، من خلال التفكير في أخلاقيات أفعالهم ومعاملاتهم ، ومن خلال موازنة أفعالهم مقابل العواقب المحتملة. أي أن كل خروج عن منطق العرف والتفكير الأخلاقي يجعل البعض ( زمن جائحة كورونا ) يتشابهون مع تجار الحروب ، يسعون باستمرار لتصبح الكارثة أسوأ وأعمق ويجتهدون ليزيد الضرر فكلما اشتدت الأزمة، ارتفعت رؤوس أموالهم ، لا يهمهم بكاء الأطفال ولا ألم وأجاع الكبار تزداد شهيتهم للاستثمار في مآسي الناس كلما تعاظمت المحن .
نقطف من سرد التداعي الحر للكاتب /السارد ، ما يلي:
” حضر ذلك الطبيب الذي كان يهاتفنا ..ولم يتقبل احتجاجي ، ولم يراع تماما شعوري ..خرج من غرف إحدى العمليات ، ويداه – بالأحرى قفازاه – ملطخان بالدماء ، ثم طلب مني الهدوء وقال لي بالحرف دون مقدمات : “إن والدك مصاب بالسرطان …” ، كانت هذه الجمل كفيلة بأن تدخلني بدوري في غيبوبة ، ثم واصل كلامه قائلا : ” يجب أن تكون مستعدا ماديا ، سنجري له عملية مستعجلة ، وسيحتاج للبقاء في الانعاش مدة خمسة عشر يوما ، وتكلفة كل ليلة لا تقل عن ستة آلاف درهم ! … أطلعت صديقي وجاري ” موحا ” على شكوكي عبر اتصال هاتفي ، فنصحني بألا أثق في كلام هذا الطبيب ، فأخذت من فوري الملف الطبي ، وتوجهت برفقة جاري …سلمت الملف الطبي للوالد إلى دكتور ، وبعد تفحص ،ودراسة ابتسم ، وقال : ” إن الأمر بسيط ..إنها بعض الحصى في المرارة قد سبب التهابا ، والوالد سيحتاج لعملية تستغرق ساعتين ، ويمكنه أن يرتاح بعدها في المستشفى – وفي غرفة عادية – ليلة أو ليلتين ، بعدها يعود إلى منزله ” (ص 111 و 113)
ازدادت مأساة المتاجرة في آلام الناس وقت انتشار فيروس كورونا و صاحبها صدمات ومفاجآت وأزمات هزت دولا وأفرادا وجماعات ، بل تعاظم نفوذ القوى المهيمنة الغاشمة ماديا ومعنويا . فالمتاجرة بآلام الناس أصبحت سلعة تحقق مكاسب وأرباح على حساب الآخر الذي لا حول له ولا قوة .
ومما نشهد به من الرواية عن مأساة الاتجار في مآسي البشر ، الآتي :
“لقد دست في قبضة يده – منذ البداية – مبلغ 2000 درهم مقابل قنينة فارغة ستعيدها له بعد انقضاء الحاجة إليها ، ثم أصبح يأخذ سبعمائة درهم عن كل تعبئة لهذه الانبوبة التي تصبح فارغة بعد عشر ساعات من الاستخدام ..عادة هو يحضر بديلا يسرب الأكسيجين ! وإذا حاولت الاستفسار منه، قد يقفل هاتفه في وجهك ! … حيث اضظرنا أخيرا للبحث عن شخص آخر …فقد تعرفنا على شاب …يغير الأنبوبة بأربعمائة درهم بدل السبعمائة ، ويحسن التكلم والتعامل …” ( ص 136 و 137 ) . ويضيف الكاتب/ السارد قائلا : ” مجرم حرب آخر قادنا الفيروس اللعين إلى أن نتعرف عليه ..إنه سائق إحدى سيارات الإسعاف الذي تكلف بإرجاع أختي شمس من المصحة إلى المنزل وهي في حالة حرجة …في هذه الظروف الصعبة أنزلها هذا النكرة في آخر الحي ورفض إيصالها إلى باب المنزل بحجة الازدحام ، وهي التي معدل تنفسها آنذاك في حدود 85 ..نعم ، سمحت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتركها ، بعدما تسلم 700 درهم عن توصيلة لا تتعدى عشر دقائق ! …” ( ص 137)
الباحثون من ( دول – أفراد – شركات ) عن الاغتناء السريع من جائحة كورونا ، متواجدون في مختلف الميادين الحياتية ، كما أن هؤلاء لم يدخروا أي جهد في تحويل الفيروس إلى ضارب ومدمر ، وهو ما يذكرنا بتجار الحروب والأزمات الذين لا هم لهم إلا تحقيق الأرباح في وقت وجيز.
خاتمة :
إن ثيمة فلسفة الموت تحمل في تأملاتها الكثير من المفارقات والتناقضات ، حسب القناعات والتوجهات الفكرية ، وهي موضوع أزعج واستفز التفكير الفلسفي ، لهذا نجد الناس قد أدركوا ذلك، فنجدهم يتناسون الموت، معتبرين أن الحياة موت في ذاته ، و لأن الإنسان يقترب من موته بعد كل يوم يمرمن عمره ، كما أن أيام عمره –هذه- هي” الفترة التي تستغرقها عملية وفاته ” . الإنسان يحيا الحياة بكل ملامحها وصورها . وفي هذه الحياة يهيئ كل أسباب فنائه وموته .
لقد سجل تاريخ الأدب العالمي أعمالا تسيدت الساحة الأدبية والنقدية …منها غارسيا غابرييل ماركيز و روايته “الحب في زمن الكوليرا” ورواية “عيون الظلام” التي تنبأت بالفيروس منذ 1981
ورواية “العمى” للروائي البرتغالي “جوزيه ساراماغو ” … وتقثنا كبيرة في العقل العربي القادرة على أن ينتج اعمالا أدبية خالدة تتخذ من زمن جائحة كورونا موضوعا لها .
عبدالرحمان الصوفي / المغرب
المراجع والمصادر :
1 – محمد الخرباش / مذكرات واقعية ( مذكرات واقعية (رواية ) رحيل بلا وداع ))/ / الطبعة الأولى / 2021
2 – مريم فتحى عبد المقصود / السيرة الذاتية ل” مريم فتحي عبدالمقصود ”
3 – الواحدي / الموسوعة الشاملة / شرح ديوان المتنبي
4 – قصة الحضارة / ويل ديورانت / ج1 / ص 100
5 – ابن عبدالبر / الموسوعة الشاملة / بهجة المجالس وأنس المجالس
6 – جريدة الشرق الأوسط / 2 أكتوبر 2008، العدد 10901
7 – السيرة الذاتية للأديب ” محمد الخرباش ”
8 – المكتبة الشاملة الحديثة / كتاب : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق / ابن مسكويه
9 – المصدر ( 8 ) نفسه .
10 – إيليا حاوي / الشعر العربي المعاصر / بدر شاكر السياب / الجزء الثالث / عدد 19 / ص 114 / دار الكتاب اللبناني بيروت
11 – عبدالرحمن بدوي / الموت والعبقرية / دار القلم
12 – عبدالرحمن بدوي / الزمان الوجودي / بيروت / دار الثقافة 1973
13 – ابن شهيد / بوابة الشعراء /
انظر أيضا :
– حرائق السؤال / حوارات مع خورخي لويس بورخيس، وامبرتو إيكو، وألان روب ـ غرييه، ولورنس داريل /ترجمة محمد صوف / دار أزمنة، الأردن، 2006 .
– توماس كليرك / الكتابات الذاتية: المفهوم، التاريخ، الوظائف والأشكال / ترجمة محمود عبدالغني /دار أزمنة، الأردن، 2005 .
– جورج ماي / السيرة الذاتية / ترجمة – – محمد القاضي وعبدالله صولة / بيت الحكمة، تونس، 1992 .
– خليل شكري هياس / المفهوم والحدود في ضوء نظرية الأجناس الأدبية .
– الموسوعة الذرائعية – النظرية الذرائعية في التطبيق / عبدالرزاق عوده الغالبي – الذرائعية والعقل / عبدالرزاق عوده الغالبي – الذرائعية وسيادة الأجناس الادبية / عبدالرزاق عوده الغالبي – الذرائعية بين المفهوم الفلسفي واللغوي / عبدالرزاق عوده